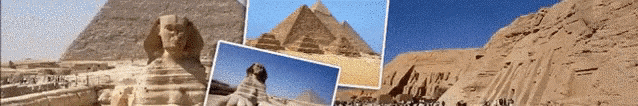د. أحمد يوسف أحمد
بمجرد إعلان أنباء الزيارة التي قام بها وفد تركي رفيع المستوى إلى إسرائيل، يومي 16 و17 فبراير الماضي، تابعتُ تصريحات لمحبي تركيا في بعض الفضائيات؛ مفادها أن هذا الوفد سيقوم بمهمة وساطة.. بين إسرائيل والفلسطينيين، لإحياء عملية التسوية الراكدة حالياً، وقد توفرت لهم الجرأة للإدلاء بهذه المعلومات، والتحليلات الخاطئة.. دون سند، مع أن أحداً من طرفي الزيارة.. لم يتلفظ بما يفيد بوجود أساس لهذه المعلومات والتحليلات، فقد كان الطرفان واضحين منذ البداية؛ في أن الغرض من الزيارة.. هو التمهيد لزيارة الرئيس الإسرائيلي لتركيا الشهر القادم.
وكان أقصى ما يمكن أن يشير.. إلى وجود علاقة للزيارة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، هو الإشارة إلى بحث الطرفين.. لمختلف القضايا الإقليمية، وكذلك تصريح الخارجية التركية.. باجتماع متوقع للوفد بمسؤولين فلسطينيين، بينهم الرئيس الفلسطيني.
وأغلب الظن أن محبي تركيا – الذين تطوعوا بالحديث عن وساطة تركية – كانوا يهدفون إلى تحسين صورة تركيا.. لدى مَن اعتبروها – يوماً – حامية حمى العرب والفلسطينيين، منذ موقف أردوغان الشهير في مواجهته مع شيمون بيريز، في مؤتمر دافوس 2009، ومحاولة السفينة التركية «مرمرة».. فك حصار غزة في 2010، والنهاية المأساوية التي انتهت إليها المحاولة، بعد مداهمة القوات البحرية الإسرائيلية لها، وكذلك سحب السفير التركي من إسرائيل، وترحيل السفير الإسرائيلي من أنقرة في 2018، احتجاجاً على استشهاد عشرات الفلسطينيين.. برصاص القوات الإسرائيلية على حدود غزة.
وفات هؤلاء، أن زمن هذه التحركات قد ولى، وأن تركيا قد بدأت محاولة العودة إلى سياسة «تصفير المشكلات».. منذ عام 2020 مع الجميع، ويلاحظ أن هذه اللعبة تتكرر.. مع كل سعي للتطبيع مع إسرائيل، بالتصريح بأنه سوف يخدم القضية الفلسطينية، وهو ما لم يحدث أبداً، وحتى لو صدقنا ما ذهبت إليه هذه الآراء عن وساطة تركية.. فإن كل المؤشرات تفيد بأن أفقها لابد وأن يكون مسدوداً.
يُظهر الوضع الراهن لعملية التسوية السلمية لما تبقى من الصراع العربي-الإسرائيلي، أنه يمر بحالة من الجمود؛ سواء في مساره الفلسطيني، الذي انقلبت فيه إسرائيل على اتفاقية أوسلو وتوابعها.. ماضية في تنفيذ مخططها الاستيطاني في الضفة – وبالذات في القدس – بأقصى سرعة ممكنة. أو في مساره السوري.. الذي ضمَّت إسرائيل فيه مرتفعات الجولان المحتلة، وحصلت على اعتراف ترمب بذلك، ولم تراجع إدارة بايدن هذا الموقف.
ولا يمكن تحريك هذا الجمود إلا من خلال مفاتيح ثلاثة:
أولها: ضغط أمريكي على إسرائيل. وهذا مستحيل.. في الأمد المنظور، على الرغم من وجود مؤشرات على تغير ما.. في مواقف قطاع من الحزب الديمقراطي تجاه القضية الفلسطينية، لكن تبلور هذه المواقف.. إلى الحد الذي ينعكس على موقف الحزب الديمقراطي ككل – ناهيك عن التغلب على المعارضة الجمهورية – يحتاج وقتاً.. قد يمتد إلى عقود.
والمفتاح الثاني: هو تغير موقف السلطة الحاكمة في إسرائيل، وهي الآن تتسم بسمتين، لا يمكن أن تفضيا إلى أدنى درجات التغيير.. أولاهما: أنها تعبر عن أقصى درجات التشدد اليميني. والثانية: أن تشكيلها من كل ألوان الطيف السياسي في إسرائيل – بما في ذلك بعض فلسطينيي 1948- يجعل بقاءها شديد الحساسية.. للقرارات موضع الخلاف، وأولها أي قرار بتقديم أدنى تنازل للفلسطينيين.
أما المفتاح الثالث: فهو الطرف الفلسطيني. علماً بأن مواقف ظهيره العربي أصبحت – على أحسن الفروض – لفظية؛ منذ انكفأ عديد من الدول العربية على شؤونه الداخلية، بسبب الانتفاضات الشعبية في مطلع العقد الثاني من هذا القرن، ناهيك عن الدول التي أقامت – ابتداءً من 2020 – جسوراً للتعاون والصداقة مع إسرائيل. وهكذا.. فإنه لكي يحدث تغيير ما في الموقف الإسرائيلي، لابد وأن تأتي الضغوط من الطرف الفلسطيني؛ طالما أن الأطراف العربية والإقليمية والدولية.. تقصر دعمها للقضية الفلسطينية – إن وُجِد – على الصعيد اللفظي.
وتكشف دروس الخبرة الماضية، أن إسرائيل لم تقدم أي تنازل في مسار الصراع.. إلا عندما وُظِّفت القوة – بمختلف أشكالها – ضدها..
فقد قبل عبد الناصر القرار 242، على أساس أنه ينص على الانسحاب من الأراضي التي احتُلت في 1967، لكن إسرائيل لم تُعِره التفاتاً.. حتى بلغت حرب الاستنزاف ذروتها في منتصف 1970، فقبلت مبادرة روجرز.
وقدم السادات مبادرته، في فبراير 1971، التي كان ممكناً أن تفضي إلى تجميد الوضع، بعد الانسحاب الإسرائيلي من شرق القناة. لكن غرور إسرائيل صوَّر لها.. أن بمقدورها أن تحافظ على وضع الاحتلال دون تغيير، حتى فاجأتها حرب أكتوبر، فاضطرت إلى قبول الانسحاب الكامل من سيناء، بموجب معاهدة 1979.
وغزت لبنان في 1982، غير أنها اضطرت للانسحاب في العام التالي، تحت ضغط المقاومة اللبنانية، بل إن الاتفاق الذي وُقع بين إسرائيل ولبنان في العام نفسه، أُلغي بسبب الرفض الشعبي.. بعد مرور أقل من عام على توقيعه.
وعادت إسرائيل فانسحبت في عام 2000 من الشريط المحتل.. في جنوب لبنان، تحت وطأة المقاومة اللبنانية.
وكانت قد اعترفت في عام 1993 بمنظمة التحرير الفلسطينية وبتمثيلها للشعب الفلسطيني، عقب انتفاضة الحجارة.. التي تفجرت في ديسمبر 1987، وانسحبت من غزة، وفككت المستوطنات المحيطة بها في عام 2005، نتيجة العجز عن إخماد المقاومة.. التي تفجرت في إطار انتفاضة الأقصى 2000.. وهكذا.
دروس الخبرة الماضية – إذن – شديدة الوضوح، وهي أن إسرائيل لا تتبرع بالتنازلات، وإنما تُجبَر عليها. وللأسف.. فإن الأوضاع الفلسطينية الراهنة، لا تُمكِّن من ممارسة أي ضغوط عليها.. من قريب أو بعيد، فالنخبة السياسية الفلسطينية المتنفذة.. في الضفة والقطاع، تتفنن في الحفاظ على انقسامها، والاتهامات موجهة لها.. بأنها مستفيدة منه.
وتتحمل هذه النخبة – بل وباقي عناصر النخبة السياسية – مسؤولية تاريخية جسيمة في هذا الصدد، إذ تواصل انقسامها، رغم التطورات المأساوية التي حلت بالقضية الفلسطينية عربياً ودولياً، ولا مناص لتحقيق أي تقدم في مسار استعادة الحقوق الفلسطينية، من تحقيق الوحدة الوطنية، وتبني استراتيجية جامعة للفلسطينيين ترفض الاحتلال وتقاومه.
ويفزع البعض أحياناً من كلمة المقاومة؛ متحسباً لتداعيات المقاومة المسلحة على القضية.
ورغم أنها حق مشروع ضد الاحتلال.. إلا أن صور المقاومة متنوعة، بل إن بعضاً من أكثرها فاعلية.. تمثل في نضال مدني، كالمقاومة التي أنهت النظام العنصري في جنوب أفريقيا. بل إن غاندي حرر الهند بنضال سلمي محض.
ولماذا نذهب بعيداً، ولدينا – في الخبرة الفلسطينية – ميراث انتفاضة الحجارة، ومعارك بوابات الأقصى، وكنيسة القيامة، والخان الأحمر، والشيخ جراح.. وغيرها الكثير.
لنتوقف – إذن – عن حديث الوساطات، والمؤتمرات الدولية، وأشباهها.. ونغير ما بأنفسنا، حتى تتغير أحوالنا.
نقلاً عن «الأهرام».