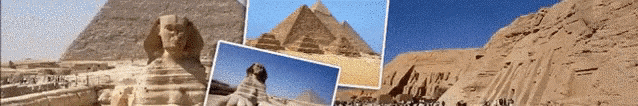التاريخ.. ما التاريخ؟
تتعدد التعريفات، ولكنا نقصد – في مقام اليوم – أن التاريخ هو «ذلك الذي يبقى في الوعي الجماعي، بعد أن ننسى ما تعلمناه».. كما قال البعض في معرض تعريف العقل.
تاريخنا هو ما نعتقد.. أو نظن، أنه هو تاريخنا بالذات. هو – إذن – ليس بالضرورة، التاريخ الذي وقع بالفعل في الماضي، أو سيقع في المستقبل، ولكنه الذي نرجح وقوعه، دون عناية خاصة بالوقائع المحددة، أو ما يجتمع في صورة واقع معين.
بعبارة أخرى، التاريخ.. قرين الذاكرة. وأما بحث مدى التطابق بين الذاكرة والواقع، بين الوعي المستكن والحقيقة أو الصدق، فتلك قضية أخرى.. يُعنَى بها «علم التاريخ».
حسْب المعنى الذي قصدناه، نجد من يقول – مثلاً – إن التاريخ يكتبه المنتصرون، وهذا ليس حقاً على الدوام، أو ليس صحيحاً في عمومه، أو ليس كله صحيحاً. وإنهم ليقولون «التاريخ»، وما هو بتاريخ واحد، ولكن «تواريخ»، فلكل فريق «روايته» الخاصة للماضي (story) في ضوء حاضره القائم، وتصوره للمستقبل.
لذلك.. أنصحك، أيها القارئ الكريم – حين تقرأ شيئاً مما يسمى «التاريخ» – أن تمعن النظر فيما قيل، وتُنعم هذا النظر فيمن قاله وكَتَب روايته؛ فهو متحيز – غالباً – لهواه، أو لمصلحته، أو للأمرين معاً. وما الهوى سوى تكوين معقد من المشاعر المتولدة من الإيمان العقائدي لشخص أو مجموعة اجتماعية، ومن مصلحة اجتماعية أو تصور للمصلحة، ومن ترسبات «ذاتية» ذات طابع إدراكي معقد، تكونت وتعاقبت طبقاتها «الجيولوجية» المتراكمة عبر الزمن.
ومن ثم فإن «الرواية السائدة» – من بين «روايات أخرى» – هي محصلة لمزيج معقد من المدركات الذاتية، والمصالح المتصورة، والرؤى العقائدية.
وهل تظُنن – مثلاً – أن ما عرفناه أو قرأناه.. عن أحوال سائدة في العصور القديمة وبعض بلدانها هو حقٌ كله.. أو صحيح؟ علماً بأن الحق والصدق في الوقائع الاجتماعية، من قبيل الأمور ذات «الطابع النسبي» في كل حال. وهذا ليس فقط.. بسبب المزيج المعقد من المشاعر والمصالح والعقائد، ولكن أيضاً بسبب نقص المعلومات، وتخلف علم الآثار والحفريات (الأركيولوجيا)، برغم الجهود المبذولة في حقل «أركيولوجيا المعرفة»، كما أشار «ميشيل فوكو».
ثم قد يكتب التاريخَ فريقٌ منتصر.. كما أشرنا في البدء، ولكن يمكن أن يكتبه أيضاً فريق مهزوم.. يتمتع بملَكة «الرواية» – الحكي أو «القص»، وبشيء من المقدرة على «إنفاذ» رؤيته بين «العموم» – أو في شطر مؤثر من هذا العموم، كما يقال في بعض أدبيات علم الاجتماع الحديثة.
***
إن لكل جماعة اجتماعية «حكاؤوها» المتفننون، بالحق (النسبي) أو بالباطل (النسبي أيضاً)، كما لدى الجماعات المسماة.. «العرقية»، التي نصادف حكائيها هذه الأيام، في كل مكان من مشرقنا ومغربنا العربي العتيد، وعلى امتداد «المنطقة العربية-الإسلامية المركزية»، وما حولها في آسيا وأفريقيا، وكذا في عالم الأمريكتيْن وما حولهما في المحيط.
ويجْهَد «الحكاؤون».. في كل من هذه الجماعات الاجتماعية على اختلافها، من أجل خلق أو «اختلاق» تاريخ، لتثبت بها روايتها السائدة، التي قد تكون باطلة من الأباطيل، بمعيار «التاريخ الإنساني» القويم. ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك: اختلاق «إسرائيل القديمة».. من باطن بعض الروايات التوراتية، غير المُثبَتة على الأقل.. في محاولة عقيمة لإثبات صحة رواية إنشاء «إسرائيل».. تلك الجديدة والقائمة اليوم، وحتى يوم قادم قريب.
أما الجماعات المسماة «العرقية» – المنبعثة حديثاً في ظروف فريدة ربما معلومة، في قلب عملية التوظيف السياسي الجارية من الجميع على قدم وساق – فإنها بازغة من بين أحشاء التركيبات الجيولوجية للأمم والشعوب الحاضرة.. وهي كثيرة الآن، قائمة بين ظهرانينا عربياً، وعلى امتداد «المنطقة العربية-الإسلامية المركزية» و«العالم الإسلامي»، تحيط بنا رواياتها المتضاربة من كل جانب.
ولسوف أنزع ما يسمونه.. «الحساسية» المفرطة، لأَذكر طرفاً من الروايات «الأمازيغية» و«الكردية» بل و«الآشورية» و«الفينيقية» وما إليها.
تلك التكوينات.. المسماة بالعِرْقية – فيما يتعلق بالجانب العربي – هي تكوينات تاريخية محقة، دخلت في خضم عملية التكوين التاريخي الأشمل.. للأمة العربية (حتى لو كانت في رأي البعض «أمة قيد اكتمال التكوين»)؛ في إطار استكمال الكيان السياسي والاقتصادي العربي.. ثم إن هذه التكوينات العريقة، بقيت قائمة داخل الأمة.. على نحو أغْنى، لتصير ذاتيتها جزءاً لا يتجزأ من البنيان العربي القومي الأشمل، دون تناقض مفتعل بين الجزء والكل، ولا بين الانتماءات الفرعية والانتماء الرئيسي الضام.
نشير أيضاً – على سبيل عرض التوظيف السياسي للتاريخ – من مثال قريب، إلى أنه حدث نوع من الانقسام «العمودي» و«الأفقي» العميق، بين أفراد شعبنا العربي في مصر، عبر نصف القرن الأخير، من النُخَب ثم من الجمهور العام، بين فريقين:
أولهما: فريق (تفرغ) تقريباً للترويج لرواية سياسية جارية، تقول إن «السادات بطل الحرب والسلام» و«سابق عصره»، بينما يشيعون أن الرئيس جمال عبدالناصر كان مجرد «عسكري»، و«مستبد»، و«عدو للأغنياء».
وثانيهما: في المقابل، يُبرِز جمال عبدالناصر.. مؤسساً للمسار الوطني التنموي لمصر العربية المعاصرة، قاعدة لحركة التحرر العربي المعاصر.. برغم ثغرات وأخطاء.
هذا مثال نذكره عرَضاً، ويدي على قلبي، وأصابعي مرتعشة، من فرط تداعيات الانقسام بين روايتين لفريقين:
… رواية شبه سائدة، تتغلغل بين شطر من النخبة ومن العموم؛ هي رواية «ساداتية» – إن صح التعبير – بلغت – لدى البعض – مبلغ القول – مثلاً – إن حرب أكتوبر هي «حرب السادات!»؛ متجاهلة عن عمْد.. كل ما هو غير ذلك، أو ما هو عكس ذلك.
ورواية أخرى – في المقابل – مهمشة عمْداً إلى حد بعيد، ترى في جمال عبدالناصر.. عكس ما يرى ذوو الرؤية التأريخية «الساداتية»، فيكون عبدالناصر الزعيم العربي «التاريخي» الفذ، الذي لم يظهر له نظير منذ مئات السنين.
وانظر للمقارنة في أمر مشابه، بين صورة «محمد علي باشا» في الذاكرة الجمعية للعرب عموماً، بمن فيهم الشعب المصري، فستجده «مؤسس الدولة الحديثة» في مطالع القرن التاسع عشر. وبين صورته لدى شطر من المؤرخين الثقات (مثل خالد فهمي.. في كتابه «كل رجال الباشا»)، باعتباره مؤسس إمبراطورية عسكرية.. وقودها الناس – من الفلاحين – والحجارة، كما فهمنا، وهذا ما نميل إليه على كل حال.
في هذا السياق، شرع الجادون من بعض رجال الصحافة الأفذاذ – تنقيباً في الأضابير وبين دفاتر الأحداث الجليلة – سعياً إلى استجلاء طرف أو أطراف من الحقيقة الغائبة، (مثل ما فعل محمد حسنين هيكل في سجل «التاريخ» المصري المعاصر.. من بعد ثورة 23 يوليو 1952)، بينما هزل الهازلون بلا وجل، وهم كُثْر.
***
ولكن.. فليقلْ كلٌّ ما يراه، ولتتعدد الروايات.. لا بأس، ولتكتب «التواريخ»، ولْينشط الحكاؤون، ولتتوسع وتتعمق كتابة «المدونات الأكاديمية» المطولة أو المختصرة، عالمياً وعربياً-مصرياً، حتى لو كانت من «أرنولد توينبي» أو «وُل ديورانت» أو من عبدالرحمن الرافعي.. مقابل محمد أنيس، وبينهما محمد عزت عبدالكريم، وحتى لو كانت من الراحل «عبدالعظيم رمضان» مقابل «علي بركات» مثلاً، أطال الله بقاءه.
وقد كان هذا هو الشأن دائماً: تضارب في الروايات، وتحيز أو انحياز متفاوت؛ بين انحياز أعمى، وانحياز بصير، ويجد كل منهما مجالاً للتصديق بين العامة.. في السوق الواسعة للأفكار. ولسوف يظل الأمر كذلك إلى أمد غير معلوم.
ولكن إلى متى..؟ متى يظهر (التاريخ-التاريخ)؟
هذا ينقلنا نقلة واسعة.. إلى «علم التاريخ»، الذي لم يستوِ عوده الممشوق بعد – برغم ضرورته، وبرغم طول فترة حضانته المديدة لآلاف السنين – منذ صحائف مصر القديمة.. والعراق القديم، مروراً بهيرودوت.. حتى اليوم.
لقد تقدمت منهجية البحث التاريخي تقدماً لافتاً، ولكنها لم تتزود تزوداً كافياً بأمرين:
أ – مادة التاريخ الحية والميتة، المكتوبة والشفاهية، والمصادر الموثقة، في ضوء فتوحات علم الآثار وبحوث الحفريات والأنثروبولوجيا، مع الأخذ في الاعتبار أنه «بين سلطة العلم، وسطوة الهوى.. خيط رفيع».
ب – المؤرخ الصادق الأمين، المؤهَل بما ينبغي له حقاً.
وما بين التاريخ.. الذي نعيه في داخلنا، وعلم التاريخ الذي نرنو إليه، يجب أن ينهض المعنيون بمادة البحث، وبمناهجه، وأعلامه المبرزين.
ولسوف نظل نتأرجح عبر الزمن.. بين التاريخ، وعلم التاريخ.. آملين أن يتقدم العلم رويداً رويداً، جزئياً ونسبياً.. نعم، من أجل أن يحل العلم – بأريحية – محل ركام الأساطير.
* أستاذ باحث في اقتصاديات التنمية والعلاقات الدولية.
نقلاً عن «الشروق».