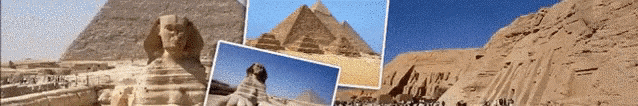حسام بدراوي
كنت في حضرة مجموعة من شباب الحالمين بالغد.. وذويهم، وسألت الجميع.. عما يخطر ببالهم، عندما أذكر أسماء بعض البلاد؛ لمعرفة الانطباع الذي ترسَّب في وجدانهم.. عن هذه الأمم.
وعندما كررت سؤالي مع آخرين.. من تجمعات أخرى، كان هناك شبه توافق على التالي:
– ألمانيا: الجدية والدقة والالتزام، والقسوة على النفس والغير.
– إنجلترا: البرود والنظام، وأدب الحوار والاستعمار.
– فرنسا: الشياكة والثقافة والتعالي، والاعتزاز باللغة.
إيطاليا: الجمال والأناقة والموضة، والحماسة الشديدة.. والمافيا.
– اليابان: التقاليد ومظاهر الأدب، والإنجاز.
– الصين: العمل كفريق والقوة الجمعية، والتاريخ والخوف.. وغموض المشاعر.
– أمريكا: الضخامة.. والحرية والإبداع، وعدم المصداقية.. والاستقواء المتهور.
– روسيا: الوجوم والعنف.. وعدم الرحمة، والبولشوي.. وتولستوي وتشايكوفسكي.
ـ السعودية: البترول.. والمال، والسلفية والحج.
– أفريقيا: الثروات المنهوبة.. بواسطة الاستعمار، والحكومات الوطنية على السواء. والظلم والاستعباد.
– مصر: التاريخ والحضارة والتنوير، والفرص الضائعة، والتواكل وعدم الجدية.. وتشتت الإحساس بالهوية.
قادنا الحوار.. حول ما تتمتع به الشعوب من صفات، إلى تساؤلات.. مثل، هل يمكن فصل الانطباع.. الذي يأتينا من شعب ما، عن الانطباع الذي يتكون من تصرف حكومات هذه الأمم!
الذي أعلمه – مثلاً – أن الشعب الأمريكي.. شعب جميل المعاشرة، بسيط، ومن الممكن التكيف معه، ولكن حكوماته عبر التاريخ – كما يقول المثل المصري – «المتغطي بهم عريان».
كذلك الشعب البريطاني.. صاحب القواعد وأدب الحوار، وإعطاء كل صاحب حق حقه. فإن حكومته استعمارية، وتدخلاته في حياة الشعوب الأخرى.. كانت – ومازالت – مأساوية متعصبة، وسبباً في خلق كل مآسي الشرق..
ثم امتد الحوار حول بلادنا، وهويتنا المصرية، والتغيرات التي حدثت في الشخصية المصرية.. في التاريخ الحديث؛ من التنوير والانفتاح.. في بداية القرن العشرين، إلى الانغلاق والسلفية.. في نهايته؛ تحت تأثير الفقر، والزيادة السكانية الرهيبة، وانتشار الفكر الوهابي السلفي المتطرف، مع غياب القيادة الواعية، التي ترسم الطريق.. بعقل ووعي؛ يبني وجدان الأمة، ولا يتركها مشتتة الفكر، ويبني على حضارة عظيمة.. خَلّفها له أجداده، ويؤجج وهج شعلة تنوير.. كان من الممكن أن تضيء مستقبل أمة، تحمل جينات العظمة والريادة.
اتفقنا على أننا – من منطلق إيجابي – علينا أن نحقق الركيزة الرابعة.. من رؤية مصر 2030 في التعليم؛ وهي «بناء الشخصية المتكاملة للتلميذ والطالب.. في جميع جوانبها، ليصبح مواطناً سوياً؛ معتزاً بذاته، مستنيراً، مبدعاً، فخوراً ببلاده، منتمياً إليها ولتاريخها، شغوفاً ببناء مستقبلها، قادراً على الاختلاف، وقابلاً للتعددية. علماً بأن ذلك لا يتم.. دون الثقافة، وممارسة الفن والموسيقى والرياضة».
وقادنا الحوار، إلى أننا يجب ألا نفصل بين الهوية والمواطنة، التي هي – بمعناها الأساسي – علاقة الفرد بالوطن.. الذي ينتسب إليه، والتي تفرض للمواطن.. حقوقاً دستورية، وعليه واجبات.. منصوصاً عليها دستورياً. وإلى جانب ذلك، فإن المواطنة الإيجابية لا تقتصر على مجرد دراية المواطن بحقوقه وواجباته.. فقط، ولكن حرصه على ممارستهما؛ من خلال شخصية مستقلة، قادرة على حسم الأمور لصالح هذا الوطن.
ويؤدي التطبيق المجتمعي.. لمفهوم المواطنة – في كل المؤسسات – إلى تنمية مجموعة من القيم والمبادئ.. والممارسات التي تؤثر في تكوين شخصية الفرد، وتنعكس على سلوكه.. تجاه أقرانه، وتجاه مؤسسات الدولة، وكذلك تجاه وطنه.
أما مفهوم الانتماء للوطن، فيمكن القول إنه.. الارتباط الفكري والوجداني بالوطن؛ الذي يمتد ليشمل الارتباط بالأرض، والتاريخ، والبشر، والحاضر، والمستقبل. وهو بمثابة شحنة.. تدفع المرء إلى العمل الجاد، والمشاركة البنّاءة.. في سبيل تقدم هذا الوطن ورفعته، وهذا يرتبط أيضاً بفخر المواطن بتاريخه، وإيمانه بمستقبله. وهي أمور لا تحدث وحدها، بل يكتسبها الطفل والشاب.. من أسرته، ومدرسته، وجامعته، وعمله.
والانتماء للوطن، لا يعتمد على مفاهيم مجردة، وإنما على خبرة معيشة.. بين المواطن والوطن. فعندما يستشعر المواطن – من خلال معايشته – أن وطنه يحميه، ويمده باحتياجاته الأساسية، ويحقق له فرص النمو والمشاركة، مع التقدير والعدل، تترسخ لديه قيم الانتماء له، ويعبّر عنها.. بالعمل البنّاء لرفعته.
وأخذَنا الحوار إلى مجموعة القيم.. الواجب إرساؤها في أطفالنا وشبابنا، وبناء مشاريع لتأصيلها.. حتى يكون لمصر – في الحاضر – شكلٌ يعبِّر عن مضمونها.. التاريخي والمستقبلي.
والقيم.. ليست شعارات تُرفع، وإنما قناعات تُترجَم.. من خلال تصرفاتنا وسلوكنا، وتعاملنا مع الآخرين؛ هي مبادئ.. مُتضمَّنة في أفعالنا وعلاقاتنا.وكنت مع شباب الحالمين بالغد قد اتفقنا على مجموعة القيم الواجب تأكيدها في الإعلام والتعليم ومنابر الثقافة والمعرفة، وهي قيم:
– الحرية.. والعدل.. والمسؤولية.
– الصدق.. والنزاهة.. والأمانة.
– العلم.. والدقة.. والإتقان.
– الشجاعة.. والمواطنة.. والسماحة والرحمة والإحسان.
– الغفران والرأفة.. والامتنان والبر والتكافل.. والصبر الإيجابي.
– الجمال.. والسعادة.. والقناعة.
– الصداقة والمحبة.. والعطاء.
ولَعلّ من الواجب، أن أضيف أهمية اللغة.. في بناء الشخصية المصرية، وتحقيق أهداف هذه القيم؛ لما للغة.. من عظيم الأثر على كل مناحي الحياة.. في أي أمة؛ إنها جزء أساسي من هويتنا، وهي الوسيلة.. التي تنقل إلينا تاريخنا، وتوثق حاضرنا، وتنقل إلى الأجيال القادمة حضارتنا.
وليس الهدف.. هو القراءة والكتابة فقط؛ فهذا هدف ضيق.. قصير المدى، لكن علينا أن نفهم أن هذه اللغة.. هي وسيلة فهمنا لبعضنا البعض. إننا لا نستطيع أن نفهم أنفسنا.. ولا بعضنا البعض.. دون التفكير. ونحن لا نفكر في فراغ، بل يفكر العقل.. بلغة ما، ويصور أفكاره – لديه وللآخرين – مستخدماً الألفاظ والجمل، والصور، التي ترسمها اللغة، وتنقلها من فرد إلى الآخر، أو الاحتفاظ بها في الذاكرة. ومن كل هذا.. تتكون الهوية.
إن تعلم اللغة الأم – وأي لغة أخرى – في سن مبكرة.. يدرب الفرد على التفكير المتعدد بين اللغات، والمتعارف عليه.. أن الأطفال، هم أقدر من الكبار.. على تعلم لغات متعددة. وحين تترسخ في وجدان الطفل.. لغته الأم، فمن الواجب أن يتم تعليمها.. على أعلى مستوى، وقياس قدرات الأطفال – على الكتابة.. والقراءة.. والفهم – من سن ثمانية إلى تسعة أعوام، باختبارات قياس علمية.
إن اللغة – لِحَياة الفرد – ليست فقط.. أداة للتواصل في المجتمع، بل هي وسيلته للتفكير والحس. وهي وسيلته لنقل أفكاره.. والاستفادة من أفكار الآخرين. وهي وسيلته في الفهم والتقدير والتقييم، ثم الاختيار بين البدائل.
والآن، يدور في الأذهان سؤال: هل معنى تعلم لغة ثانية.. أو استخدام المراجع الأجنبية، يهدد الهوية؟ وهل.. من الصحيح، ألا يتعلم الطفل لغة أخرى.. في مراحل التعليم الأولى؟
الإجابة القاطعة.. هي لا.
فتعليم لغة أخرى.. لا يهدد الهوية، ولا يهدد معرفة اللغة الأم، إلا لو كان تعليم اللغة الأم.. ناقصاً وضعيفاً من الأساس.
إن الطفل يستطيع استيعاب لغات متعددة.. أكثر من البالغين، ويجب ألا نتمسح في أن تعليم لغة ثانية، سيتغلب على لغته العربية، ويجعل تفكيره وهويته.. مرتبطين بأمة أخرى. فرفض ذلك يجعلنا.. كمن لا يريد دخول ميدان العلم مع الآخرين؛ خوفاً من الهزيمة، ونستحسن فوزنا بدون منافسة.
إن الهوية – كما قلت – مرتبطة باللغة، ولكنها أيضاً مرتبطة بالمعايشة.. في الفصل المدرسي، وبما يدرسه التلميذ.. من تاريخ وجغرافيا، وبوجدان يتكون داخل الفصل والمدرسة، وفي البيت مع الأسرة.
إن أطفالنا الذين يتعلمون اللغات الاخرى في مدارس الحكومة – البالغة أكثر من 50 ألف مدرسة – لا يتكلم أغلبهم اللغة العربية الصحيحة، ولا اللغة الأجنبية الصحيحة. والحقيقة.. أن هويتهم مشتتة؛ لأن العقل الجمعي لأمتنا.. مشتت الهوية؛ بين الفكر السلفي.. الذي يؤكد الهوية الدينية، والفكر القومي.. الذي يؤكد الهوية العربية، والفكر الوطني.. الذي يؤكد الهوية المصرية.. بتعدد مصادرها.
وعلينا أن نكون أكثر واقعية.. عندما نناقش الهوية والانتماء والمواطنة، لأن غرسها في وجدان الطفل.. مركب، ومتعدد المداخل.
والسؤال هو: هل نقوم بواجبنا.. لتحديد مَن نحن، ليعرف شبابنا من هم؟!
نقلاً عن «المصري اليوم».