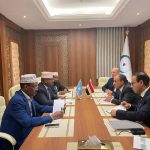عادل نعمان
ولا يفاجئك قول غريب.. حين يعتادون إهانة الأوطان، أو يحقرون ماضيها، أو يستخفون بمستقبلها، أو ينتقصون من قيمة علم من العلوم.. يرفع شأن البلاد والمواطنين، أو يبخسون أجر من ضحَّى في سبيل وطنه.. ومات عزيزاً شهيداً، أو يستخفون بمشاعر غير المسلمين، وحرمانهم رحمة ربك.. التي وسعت كل شيء، ولا يكرمون ولا يعظمون.. إلا ما كان له صلة – من قريب أو بعيد – بالدين، حتى لو كان ملمحاً أو مشهداً عابراً أو عارضاً، أو من طرف خفي، أو قربى.. لا يجتمعان عليها في مسرة أو نكبة. المهم أن يكون مصبوغاً بصبغة دينية، أو محمولاً على قلنسوة أو عمامة.. ولو كانت صبغة ضلال وبهتان، أو كان حاملها يعلم مرادها أو لا يعلم.
وإليك بعضاً من أقوالهم عن الوطن الذي يؤوينا، ونستظل بظله، ولا كرامة لنا دونه: فهذا إمامهم حسن البنا يقول «يجب أن نصل إلى أستاذية العالم، والوطن وسيلة وليس غاية !!» والفارق كبير بين الغاية والوسيلة؛ فالوسيلة هي السبيل والطريق.. مهما فزع أو تردى أو احتضر، والغاية تبرر الاستبداد والطغيان والظلم والفساد.. مهما تنوع. وفي موقع آخر لنفس الإمام.. «وجه الخلاف بيننا وبين دعاة الوطنية، أننا نعتبر حدود الوطنية بالعقيدة، وهم يعتبرونها التخوم الأرضية والحدود الجغرافية»، وفاتت على إمامهم أن الوطن.. يعني الأمان والسكينة والحرية؛ فلا حرية بلا أمان ولا دين بلا وطن. وهذا مرشدهم المهدي عاكف يقول: «الإخوان فوق الجميع»، وفي آخر: «إيه يعني مصر.. طظ في مصر». وأما ما قاله منظر الإخوان «سيد قطب»، فقد زادها بللاً حين يقول: «وما الوطن إلا حفنة من تراب عفن، أما نحن فوطننا الإسلام». وكأن هذا «السيد».. يرى أن عبادة الله بين الأطلال والخراب والفقر تحت شعاراتهم، أفضل من عبادة الله في وطن عامر.. تحت سلطان غيرهم.
ولقد وصل التطرف الفكري مداه، حين أطلقوا على الوطن لفظ «الوثن».. وهو الصنم الذي يُعبد من دون الله. وكأن حب الوطن.. منكر وضلال وكفر بواح. وفرض الإخوان مسميات بديلة، يستخدمها أعضاء التنظيم.. تنأى بالجميع عن معنى الوطن «الأممية، التنظيم، البيعة، الشعبة، الأسرة، المحب، المؤيد، العامل، النقيب». وفي هذا يقول حسن البنا: «الإسلام هو الوطن والجنسية». وهذا سيد قطب يقول: «جنسية المسلم عقيدته»، فاستبدلوا حدود الأوطان الجغرافية، بحدود من المعتقدات والمبادئ، ويصبح الوطن داخل كل فرد.. ممتدا بمساحة أفكار التيار السياسي لكل الجماعات.. على حدود الكرة الأرضية.
والدين – كما قرروا – هو جنسية المسلم. والإسلام.. هو الوطن الذي يسكنه. والدولة، سكانها.. إما مسلمون مؤمنون، أو ذميون معاهدون. وحدودها دار سلام، وجوارها ديار حرب.. وهذا ما قاله الشيخ محمد الغزالي: «إن وطن المسلم عقيدته، وحكومته شريعته، وإن ديار الإسلام ومن عليها فداء للإسلام». ولما كان «المسلمون إخوة»، فإن المسلم الهندي أقرب للمسلم المصري.. من القبطي الذي يجاوره في السكن أو العمل «عن صلاح أبو إسماعيل». فما أعجب هذا التشبيه.. وما أغربه، أن يكون الغريب أقرب من جارك.. الذي يجيرك إن استجرته أو استصرخته. أما المهدي عاكف، فإنه يزيد الأمر غرابة.. حين لا يمانع «أن يحكم مصر مسلم ماليزي عن المصري القبطي»، وكأن الدولة قد عقمت ونضبت.
ولا يكتفون بهذا، بل جميعهم يحرمون على من مات في سبيل الوطن والعرض.. شرف الشهادة، بل ويحصرونها فقط فيمن مات في سبيل الله والدين؛ وكأن من مات مقاتلاً، ومعتدياً على خلق الله.. أسعد حظاً، وأوفر نصيباً.. من الذي مات دفاعاً عن شرفه ووطنه وحدوده. هذا ما قاله الشعراوي وسيد قطب وكل قيادات الإسلام السياسي. وفيما قاله ابن عثيمين: «نقاتل دفاعاً عن الإسلام، أو عن أوطاننا التي فيها الإسلام.. لأجل الإسلام الذي فيها. أما أن نقاتل عن الوطن فقط.. لأنه ترابنا ومسقط رؤوسنا وما أشبه ذلك، فهو قتال جاهلي، وما قتل فيه ليس من الشهداء».
والدولة الحديثة.. هي دولة المواطنة أولاً؛ علاقتها بحدود الوطن، والمواطن.. الذي ينتسب إليها، وليست في حدود الدين.. سواء دين الأغلبية أو الأقلية، وهي بهذا تنتصر للاستقرار، وتمنع تغول دين الأغلبية على ديانات الأقلية. والدولة الحديثة محايدة تماماً – مع المنتمين لها – تجاه الأديان والأجناس والأعراق، وعقدها بين الدولة وبين المواطن، وليس بين دين من الأديان، وإلا كانت العقود تمييزية عنصرية.. تنتفي معها صحة العقود، وتتقاطع مع الحقوق، وتتعارض مع قيم العدل والحرية. أما الشهادة.. فهي حق لمن مات دفاعاً عن شرفه وعرضه، والأوطان أرقى وأعظم شأناً، فهي العرض والشرف والحرية.
«الدولة المدنية هي الحل».
نقلاً عن «المصري اليوم»