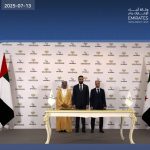أحمد الجمال
أسعى لمتابعة الشأن السوري. لأسباب عديدة؛ على رأسها أن أمن مصر يمتد – بل ويبدأ – من شمال سوريا.. أي الأناضول، وفق ما حدده أجدادنا المصريون القدامى، وأكدته مجريات الأحداث طيلة عشرات القرون، وأن ما يحدث في سوريا الآن.. يعد حالة دراسة كاشفة لما كان ينتظر مصر، لو استمر المتأسلمون في حكمها، بل ولما تسعى أطراف داخلية وإقليمية ودولية.. لفعله في مصر، ناهيك عن العوامل الحضارية والثقافية والتاريخية والاستراتيجية، التي ربطت سوريا بمصر، لدرجة أنهما ظلتا حقباً من الزمن دولة وحدة.
وعدا عما سبق، فإن ما يربطني بسوريا – على المستوى الوجداني والذاتي الشخصي – عميق؛ حيث عشرات الإخوة الأصدقاء، ورفاق الفكر والمبادئ والعمل السياسي المشترك، وحيث حنيني المتجدد.. للحضور في حضرة الشيخ الأكبر، والكبريت الأحمر، محيي الدين بن عربي، إذ طالما زرت مرقده، وأزداد أنساً بجواره، وفي شوارع حي شيخ محيي الدين.. كثيراً ما تناولت الطعام الشعبي المشبع اللذيذ!
وبصرف النظر عن الاختلاف الذي احتدم.. حول تقييم وضع سوريا بعد انهيار نظام أسرة الأسد وحزب البعث، ووصول جماعة سلفية جهادية إلى الحكم، وحيازتها – وبسرعة لافتة – قبول قوى إقليمية ودولية، وما صاحب ذلك من انهيار للدولة الوطنية، وقصم ظهر عمودها الفقري.. وهو الجيش السوري، وتمدد الدولة الصهيونية بقوة وسهولة.. في أراضي سوريا، إلا أن الصورة تتضح بسرعة أيضاً، لتؤكد معالمها أن ما يجري هناك على الصعيد الوطني الشامل – وخاصة ثقافياً وسياسياً واجتماعياً – يشير إلى أن تلك الجماعة.. التي حكمت، وحاول الرئيس المنتسب لها.. تبنِّي خطاب سياسي وإعلامي، يوحي بالاعتدال والمصالحة الوطنية؛ لم تغير أفكارها، ولم تعدل مسلكها، ولم تفارق نزوعها التشددي التمييزي.. غير المعترف بأي مكون آخر في التركيبة الوطنية.
وفي هذا السياق، لم تكن مفاجأة لي – كمراقب – أن تسعى القوى الوطنية الحية في سوريا.. للانتقال من مرحلة الترقب والتمهل، ومنح الفرصة، والتعبير عن ذلك بإشارات وعبارات هادئة متريثة، تتضمن تذكيراً وتنبيهاً بما يريده الناس.. منذ ثاروا على حكم الأسديين الطائفيين والبعثيين، ودفعوا أثماناً هائلة باهظة. كان ضمنها أرواح مناضلين.. قضوا نحبهم في السجون والمعتقلات تحت وطأة التعذيب، وأرواح شهداء بالآلاف.. قضوا بالبراميل المتفجرة ودانات المدافع وقنابل الطائرات، وتحت ركام البنايات والمنازل ودور العبادة.. للانتقال إلى مرحلة العمل المنهجي الجماعي، فتمت الدعوة لتأسيس الجبهة الوطنية السورية المعارضة، وتم إصدار مشروع الوثيقة التأسيسية، التي تلقيت صورة كاملة منها، بدأت بديباجة نصها:
«في ظل غياب التوافق الوطني السوري، وتراجع المسارات السياسية الشفافة، وتفكك المعارضة التقليدية؛ تأتي هذه الوثيقة لتوحيد الكتلة السورية غير الممثلة – في الوضع القائم – من أفراد وكيانات.. تؤمن بأن السلطة لا تنتج بالغلبة، وأن العقد لا يفرض من دون توافق، نفتح باب التوقيع على هذه الوثيقة.. لكل من يشاركنا هذا الموقف، ويسعى إلى بناء إطار يتمتع بالشرعية الأخلاقية والسياسية، ويعيد الاعتبار لمفهوم الدولة.. بوصفها عقداً، وليس غلبة».
ثم تضم الوثيقة خمس نقاط رئيسية، ونقطة سادسة هي الخاتمة.. التي نصها: «هذه الجبهة لا تعيد إنتاج معارضة تقليدية، بل تنبع من إدراك بأن الشرعية.. تبنى على التمثيل لأعلى المواقع، وعلى المراجعة لا التكرار. وأن اللحظة السورية لا تحتمل مزيداً من الإنكار أو التأجيل، ومن لا يرى في نفسه ممثلاً – فيما يدار اليوم باسم (الانتقال) عليه ألا يكتفي بالرفض، بل أن يشارك في إيجاد الحلول والبدائل.. من خلال فعل جماعي واضح، يعيد للسوريين ملكية مصيرهم، وللسياسة شرطها التمثيلي، وللدولة هيبتها الدستورية والسيادية على أراضيها كافة؛ بوصفها كياناً جامعاً وممثلاً لكافة السوريين.. لا لطرف واحد، ولا لفئة من دون غيرها«.
وتنتهي الخاتمة بملاحظة تقول.. إن هذه الوثيقة بداية لمسار تأسيس الجبهة الوطنية السورية المعارضة، التي ستمر بخطوات عديدة، بدءاً من التواصل مع الأحزاب والتيارات والأفراد الموقعين عليها، وصولاً إلى عقد مؤتمر إطلاق الجبهة رسمياً. أما النقاط الخمس التي أشرت إليها فسأحاول قراءتها في مقال مقبل.
نقلاً عن «الأهرام«