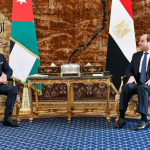عمار علي حسن
في المساحة المنطرحة بين التبة العالية، والطريق الأسفلتي الضيق.. أجد بقاياهم فوق الرمل والحصى. يمر بها الجنود مهرولين، لا يتوقفون عندها. اقتحمت عيونهم مرات.. حتى صارت جزءاً من مكان اعتبرناه حيز كتيبة الدفاع الجوي. ألفوها، فلم يسألوا عنها، ولم يشغلهم إلى أي أيام تعود.
أشياء كثيرة مبعثرة، غلبت ثمانية عشر عاماً.. مرت كلمح البصر على من رغد عيشه، بطيئة ثقيلة على المكلومين والمحرومين، وأصحاب الآمال المعلقة، والأحلام المجهضة، وأكثر.. على من خرجوا من الحرب بإصابات بالغة، تركتهم عاجزين، أو يعانون من الفزع الليلي، والوساوس والهلاوس التي تملأ رؤوسهم في النهار.
حين رأيتها، للمرة الأولى، وأنا أصعد إلى سرية المدفعية المضادة للطيران – التي صرت قائدها – توقفت ورحت أنظر إليها بإمعان شديد. وسألت نفسي: «يا تُرى من عاش من الذين التهموها تحت النار، ومن بقي على قيد الحياة.. يجتر ذكرى أيام صعبة؟»
وغرقت وأنا أقلب عينيَّ فيها، في كل ما سمعته في قريتي.. من جنود خاضوا الحرب ببسالة نادرة. حكايات كان يحلو لهم سردها على مسامعنا، ونحن نكدح في الحقول تحت الشمس الحارقة، وحين نجلس في المساء.. على مصاطب السمر في قريتنا البعيدة عن هنا.
«هل كان أحدهم هنا؟» لا أدري، لكنهم حكوا لنا عن معلبات كانت تأتيهم، يفتحونها دون تمهل، ويأتون على ما فيها، وهم في خنادقهم، أو يستعدون للزحف نحو الشرق والشمال.. لملاقاة العدو.
كل الأشياء التي حكوا عنها، وجدتها ماثلة أمامي: زمزميات ماء فارغة، يسكنها الفراغ والوسخ. بعضها عارٍ، وبعضها لا تزال عليه بقايا الخيش المهترئ، بعضها لا تزال تحط على فوهاتها أغطية، وأخرى مفتوحة تطل على الطريق. وعلب فارغة، كانت من قبل مملوءة بالفول المدمس والمربى والسردين والحلاوة الطحينية والجبن. تقشرت الأوراق التي كانت تغلفها، أو ضاعت حروفها مع الزمن، لكن هيئتها تدل عليها. تشبه إلى – حد كبير – تلك التي يتناولها الجنود في سنوات خدمتي العسكرية، ربما هي نفسها، أو أنواع أخرى، نلتهمها أيضاً في أيام السلام البارد.
طالت نظراتي إليها، وانهمرت الذكريات الحيَّة، ووجدت نفسي أجلس القرفصاء عندها، أمد يدي في حذر. أرفع إحداها إلى عينيَّ، وأنفض الصدأ الذي يعلق بأصابعي. صدأ ثقيل لا يلغي حضورها في رأسي، ولا يطمس معالمها.. التي لم ينتبه إليها من أرَّخوا للحرب، وكثير ممن حكوا عن مكابداتهم بين النار والدم وهزيم المدافع، وأزيز الطائرات – التي عبرت بغتة إلى الضفة الأخرى من قناة السويس – بعد ظهر يوم لا يُنسى.
أمسِك زمزمية، فيأتيني صوت «سعيد عبدالرازق» – جندي مدفعية الميدان – وهو يقول: «لمَّا خلص الماء، حطيت الزلط البارد تحت لساني». أما «متوكل عبدالحميد».. فلا ينسى أنه قضى أياماً بلا طعام، بعد أن انقطعت السبل بسريتهم، فيغلبه صوت «طاهر أبو عشري».. وهو يقول: «عسكري من قنا أسر إسرائيليين بعلبة فول، كان راجع بالتعيين وتاه.. فوقع فيهم، وقبل أن يصوِّبوا بنادقهم إليه، رفع علبة فول تقشرت ورقتها، فلمعت في عيونهم. ظنوها قنبلة، فخرجوا رافعين أيديهم فوق رؤوسهم. صرخ فيهم فارتعبوا، وأشار إليهم أن يمشوا أمامهم، فنفذوا أمره، حتى جاء إلينا بهم أسرى».
«أي علبة فول من هذه كانت هي؟» أسأل نفسي، ثم أتذكر أن الواقعة لم تكن هنا غرب القناة، إنما شرقها، حيث صحراء سيناء.. الممتدة إلى البعيد. أرفع علبة مدببة، غطاؤها لا يزال عالقاً بها. من فتحها في الزمن البعيد كان متعجلاً على ما بدا لي. أقدر أنها علبة سردين على أي حال. أرفع أخرى أسطوانية، وأقول لنفسي: «كانت علبة مربى»، وأردد سؤالاً.. لا توجد إجابة عليه لديَّ: «أين من أكلها الآن في دنيا الناس؟».
كنت متأكداً أنها ليست من مخلفات كتيبتنا، فنحن نضع العلب الفارغة.. في سلة قمامة هائلة، تختلط بها بقايا الطبيخ والأرز والخبز الجاف، والأفرولات المهترئة، والأحذية التي فقدت صلاحيتها، ونرمي كل هذا في حفرة بعيدة، ثم نشعل فيها النيران بعد جفافها، حتى لا تجذب الذباب إلينا.
رفعت علبة صفيح متوسطة الحجم – كانت علبة جبن – لم يكن هذا في حاجة إلى تفكير، إذ ظهرت من جانبها حروف محفورة.. تدل على ما كان فيها. سحبتها إلى الأمام، فانسحب معها خيط، ما إن جذبته.. حتى تمزَّق، وبانت لي بيادة كالحة.. مملوءة بالرمل والحصى. كان جلدها لا يزال متماسكاً، وفيَّة هي لقدم لبستها ذات يوم، ربما لا تزال آثارها باقية فيها؛ رائحتها أو الألم.. الذي نشب في أصابع من طوَّقت قدمه أياماً طويلة، فالمحارب ليس لديه وقت لخلع حذائه.
ملت أكثر، حتى جثوت على ركبتيَّ، ومددت أنفاسي أشم رائحة الذين كانوا هنا. رائحة الأشياء ضاعت في قدحة الشمس، وانهمار المطر، ودفقة الريح.. التي تدفع الرمل والحصى. كل هذا حدث – دون شك – على مدار السنوات الفائتة، لكن رائحة الآدميين لا تزال هنا. ربما هي رائحة الذين سردوا الحكايات على مسامعي في القرية، وربما رائحة غيرهم وقد كانت قوية بقدر حماسهم المستعر، فلم تبددها السنون.
نهضت دون أن أبعد عيني عما رأيت، وقطعت خطوات إلى الكتيبة، وأحضرت كيساً من البلاستيك المقوَّى، وخرقة مبللة، وهبطت سريعاً تحت التبة العالية. مددت يدي في حذر.. مرة أخرى، والتقطت من كل صنف علبة، مسحت الصدأ العالق بها، لكنه كان أقوى من أن تعود إلى لمعانها القديم.
ملأت الكيس بكل الأصناف، وربطت فوهته. وضعته إلى جانب سريري البسيط، وأنا أقول لنفسي: في الإجازة القادمة، سآخذه إلى القرية، وأسأل المحاربين القدامى عن كل شيء، فربما أفتح أمامهم باباً آخر لحكايات ضاعت من ذاكرتهم، عن الأشياء التي حاربت معهم، دون أن يحسبوا حسابها.
نقلاً عن «المصري اليوم»