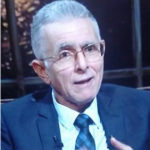نبيل عبدالفتاح..
الأسئلة التي طُرحت على العقل المصري مع صدمة الحداثة والحملة الفرنسية، ومشروع بناء الدولة الحديثة مع محمد علي وإسماعيل باشا، اتسمت بالعمومية المفرطة، والنزعة التبسيطية.. حول مفهومَي التقدم والتخلف، والدولة وسلطة الحاكم الفرد، وذلك في ثنائيات متضادة. كانت الإجابات المطروحة عامة من العقل النقلي الديني الاتباعي ودفاعية وهوياتية، وأيضاً من العقل المتطلع إلى بعض من سمات الحداثة، ذات طابع براجماتي، يركز على التعليم المدني، وسياسة البعثات إلى أوروبا (فرنسا)، وتشكيل كوادر ذات تعليم أوروبي حديث وتقني من أجل استكمال عمليات التحديث السلطوي المادي، وبناء أجهزة الدولة، وتشكيل «جماعة المواطنين» كبدايات لتكوين جهاز الدولة البيروقراطي.
النزعة البراجماتية/العملية.. هي التي سيطرت على عقلية الحاكم الفرد، وامتدت إلى ذهنيات الموظفين. كان التحديث، وبناء جيش إبراهيم باشا، والحروب التي خاضها في المنطقة، أو بعض دول أفريقيا جنوب الصحراء في منطقة حوض النيل، تمثل انعكاساً للعقل العملي السلطوي والبيروقراطي لجهاز الدولة. ومن ثم لم تكن جزءاً من المرجعيات الفلسفية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية.. لنشأة وتكوين الدولة/الأمة في ظل تطور الرأسماليات الأوروبية، وحركة القوميات. وتشكل مفهوم القومية المصرية بعد ذلك.. من خلال الكفاح الوطني من أجل الدستور والبرلمان.. قبل وبعد الهبة الشعبية واسعة النطاق عام 1919.
من محمد علي، وإسماعيل باشا، حتى اتفاقية مونترو، كان مفهوم الدولة، والقانون، والحريات العامة والشخصية، أسيراً للنزعة العملية الوضعية المسيطرة على إنتاج التشريعات والتطبيقات القضائية، وغابت عنه الأبعاد الفلسفية والسوسيولوجية والاقتصادية لمفهوم الدولة/الأمة (الدولة القومية)، ومعها مفاهيم الحرية، والسلطة، والنظام السياسي، والعدالة، والسيادة… إلخ. كرَّس هذا التوجه في النظرات الدستورية والقانونية التكوين التعليمي والرأسمال الخبراتي، الذي شكَّل ثقافة «الطبقة السياسية» في المرحلة شبه الليبرالية – خاصة المحامين – بعد الحركة الجماهيرية الكبرى عام 1919، وتشكل الطبقة الوسطى.
الثقافة والمعرفة القانونية الشكلية والعملية – التي هيمنت على العقل القانوني والسياسي المصري – اتسمت بالنزعة التعميمية المختلطة بالوطنية، والنزعة الدستورية، والسعي إلى الاستقلال الوطني، ومن ثم نادرة هي الأطروحات الفلسفية والسوسيولوجية.. حول الدولة والسلطة والدستور، والقانون، والحرية، والسيادة… إلخ. ومن ثم غاب عن المقاربات السياسية والدستورية للدولة والقانون الأبعاد الفلسفية، والربط بين الدولة والسلطة، وبين التوازنات، والقوى الاجتماعية المختلفة بين الشرائح الاجتماعية المختلفة، وطبيعة المصالح الاجتماعية الغالبة في الدولة والمجتمع المصري.
في الدولة العربية ما بعد الاستقلال، كانت معظمها مجتمعات انقسامية دينية ومذهبية وعرقية وقبلية وعشائرية ولغوية ومناطقية؛ ومن ثم كانت مقاربة الدولة.. ككائن متعالٍ، وشخصية معنوية مختلطة بالسلطة وقواعدها الاجتماعية، ومن ثم غلبت المقاربة المجازية للدولة.. التي ارتكزت على أيديولوجيات ما بعد الكولونيالية، وخطاباتها الوطنية والشعبوية حول الاستقلال الوطني والسيادة، في نظم تسلطية أو استبدادية عربية.
هذا النمط من المقاربات الشكلية.. لمفاهيم الدولة والدستور والنظام والقانون والسيادة والاستقلال والعدالة لم يستصحب معه التطور التاريخي والفلسفي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة/الأمة الأوروبية، الذي لم يتحقق في غالب المجتمعات والدول العربية. من هنا ساد الخلط بين الدولة والنظام والحكم، وبين النظرات الدستورية والقانونية الشكلية والتجريدية، وإطلاق هذه الاصطلاحات والمفاهيم.. وكأنها قد تجسَّدت في الواقع الموضوعي التاريخي؛ في كل مجتمع انقسامي ونظام تسلطي واستبدادي عربي.. يحمل في أعطافه تحيزاته ومصالحه، اعتماداً على قواعده الاجتماعية.. التي جاء منها الحاكم/الزعيم الفرد؛ بغضِّ النظر عن أيديولوجيا النظام ومجازاته السياسية المفرطة، وتبني المصطلحات والمفاهيم الأوروبية.. دونما تحقق لتجسداتها التاريخية، التي تمت ونضجت في غمار تحولات الدول والمجتمعات والنظم الديمقراطية الأوروبية.
مرجع ذلك، افتتان قادة الاستقلال الوطني، واحتفاؤهم ببعض المصطلحات الحداثية؛ ومنها الدولة والاستقلال والسيادة الوطنية، والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون؛ وهي اللغة التي تمت استعارتها من المرجعية الأوروبية.. كمحض لغة دستورية وسياسية وقانونية، لكن دون محتواها ودلالاتها، وفي جذورها الفلسفية والقانونية الغائبة، وتناقضات بعضهم في الممارسة والسلوك الدستوري والتشريعي والسياسي عن هذه المفاهيم!
كانت الممارسات السلطوية الغشوم – في بعض الدول بعد الاستقلال من نير الاستعمار الأوروبي البغيض – تنفي اللغة في معتقلات الأيديولوجيا؛ حيث الدساتير والقوانين.. محض أنساق فارغة من مضامينها، ودورها هو الخداع والتبرير، وتسويغ سياسات وقرارات السلطة الحاكمة، وذلك تحت مفاهيم العدالة الاجتماعية.. (باستثناء الحالة الناصرية، وتوسيع قاعدة التعليم، والسياسات الاجتماعية.. في ظل نظام رأسمالية الدولة البيروقراطية)، بينما الواقع الاجتماعي يتسم بالاختلالات في مجال توزيع الثروة، والأخطر مصادرة السلطة الحريات العامة والفردية في الواقع، وإنتاج شبكات من القوانين المقيدة للحريات، واعتقال المعارضين أياً كانت توجهاتهم الأيديولوجية.
أدت ممارسات ما بعد الاستقلال – في مجال الحريات الأكاديمية – إلى ضعف ومحدودية الدراسات التأصيلية والتحليلية والفلسفية.. للمفاهيم الكبرى وسردياتها وممارساتها، وانفصالها عن جذورها الفلسفية والسوسيولوجية والاقتصادية.. إلا قليلاً؛ مع عبدالله العروي، ومحمد عابد الجابري، وعبدالإله بلقزيز ومحمد المعزوز، وعلي أومليل، في المغرب، وبعضهم في المشرق العربي.. على نحو أدى إلى هيمنة اللغة السياسية المجازية الإنشائية الفارغة، ومفاهيمها المحمولة على سرديات كبرى، بينما كان الواقع السلطوي الطغياني، والقوة العمياء؛ كاشفاً عن انفصال اللغة السياسية والخطاب المحمول عليها.. عن الواقع الموضوعي المعيش، حيث اللغة الشعبوية هي تعبير عن واقع حالات تراجع السياسة في بعض الدول العربية.
نقلاً عن «الأهرام»
الدولة والسلطة والقانون ما بعد الاستقلال

شارك هذه المقالة